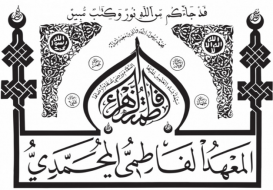الفكوك في أسرار مستندات حِكَم الفصوص
المؤلف: العارف بالله صدر الدين القونوي (ت 673هـ).
كتاب الفصوص وسبب الشرح: وبعد: فإن كتاب فصوص الحكم من أنْفَس مختصرات تصانيف شيخنا الإمام الأكمل.وهو من خواتيم مُنشئاته وأواخر تنزّلاته. ورَد من منبع المقام المحمدي والمشرب الذاتي والجمع الأحديّ،فجاء مُشتملاً على زبدة ذَوْق نبينا صلى الله عليه وسلم في العلم بالله،ومُشيراً إلى محتدّ أذواق أكابر الأولياء والأنبياء المذكورين فيه،ومُرشداً كل مُستبصر نبيه لخُلاصة أذواقهم ونتائج متعلّقات هِمَمهم وجوامع محصولاتهم وخواتم كمالاتهم.فهو كالطابع على ما تضمنه مقام الكمال لكل منهم،والمُنبّه على أصل كل ما انطووا عليه وظهر عنهم.فإن في المعلومات ما لا تستقلّ العقول النظرية بإدراك حقائقها وأسرارها، لغلبة أحكامها الإمكانية،وإن بصائرهم تَعشى عن استجلاء غوامض أسراره الكلية،وعلومه العليّة التي هي غذاء أرواح أولي الألباب،الذين خلصوا من حبوس قيود مدارك الفكر والحسّ،وخرجوا إلى فسيح حضرة القدس،فأدركوا حقائق الأشياء في مراتبها الكلية بالإدراكات المقدسة المطلقة الإلّيّة،واقترحوا عليّ أن أفُكّ خُتومه وأوضّح سرّ محتدّه وأكشف مكتومه وأفتح مُقفله بما يفصّل مُجمله.هذا مع إنّي لم أستشرح من هذا الكتاب سوى الخطبة(لا غير) لكن مَنّ الله عليّ ببركته أن رزقني مشاركته في الاطّلاع على ما اطّلع عليه والاستشراف على ما أوضح لديه والأخذ عن الله دون واسطة سببيّة،بل بمحض عناية إلهية ورابطة ذاتية يعصمني فيما أورده من أحكام الوسائط وخواص الأسباب والشروط والروابط.
فص،الحكمة،الكلمة: الفصّ: عبارة عن خاتمة علوم كل مرتبة من المراتب المذكورة في هذا الكتاب وصورة أحديّة جمعها.وهو كالروح المنفوخ في النشأة الإنسانية المُسواة.ونقش كل فصّ: الكلام المعرّب عن معنوية ذلك الفص ومعقوليته وما تشتمل عليه تلك المعنوية من حيث كُليّتها من الأمور التفصيلية والمسائل العلمية. والحكمة: عبارة عن ضوابط تلك المسائل العلمية والأحكام الكلية بطريق الحصر لها،مع التنبيه على أصل محتدّها ومُستندها من مطلق علم الحقّ،والتعريف لذاته سبحانه من حيث تعيّنه في تلك المرتبة.
والكلمة: عين ذلك النبي المذكور من حيث خصوصيته وحظّه المتعيّن له ولأمّته من حكم الحقّ الذي هو شريعته التي من حيثها يُسمى نبياً. وأما من حيث معرفته بالحقّ،ومن حيث علم الحق به وبلوازمه والمؤقّت والمتناهي من ذلك وغير المؤقت وغير المتناهي،فذلك جهة وَلايَته،ولكل كلمة كمال نسبي يخصّها. فكّ ختم الفصّ الآدمي: اختصاص هذه الكلمة الآدمية بحضرة الألوهية،بسبب الاشتراك من أحدية الجمع.فكما أن الحضرة الألوهية،المعبّر عنها بالاسم الله، تشتمل على خصائص الأسماء كلها وأحكامها التفصيلية ونِسَبها المتفرعة عنها. كذلك الإنسان فإنه من حيث حقيقته ومرتبته لا واسطة بينه وبين الحق،لكون حقيقته عبارة عن البرزخية الجامعة بين أحكام الوجوب وأحكام الإمكان،فله الإحاطة بالطرفين.
الاقتران والمناسبة بين الصفة والنبي: بدأ بالمرتبة الجامعة للصفات،وهي حضرة الألوهية،وقرنها بآدم الذي له الكمال الأول في الحيطة والجمعية. وتلاه بالعطايا الذاتية والأسمائية التي لها الأولية في المصدرية،وأورد فيها بذكر الصفات التنزيهية المُزيلة توهّم الكشف المتعلّقة في الأسماء،من حيث تعقّل من جمعها بذاته،وكذلك الكثرة الموصوف بها العطايا.
الكلمات الإلهية: وأما سِرّ تسميّة الأنبياء بالكلمات، وكذلك تسمية الحقّ سبحانه الأرواح بالموجودات،فموقوف على معرفة كيفية الإيجاد والمادة التي منها وبها وفيها وقع الإيجاد،وهذا من أعظم العلوم وأغمضها وأشرفها. وقد كنّى الحق سبحانه في الكتب المنزّلة عن التأثير الإيجادي بالقول،وهو قوله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه).فاعلم أن فعل الحق إن كان بذاته،بمعنى أن الفعل يَليه (لما يتوسّط بين ذاته وبين المفعول من نِسَب معقولة يتميّز بتعيّنها الإطلاق الذاتي عمّا تعيّنت به) كان اسم ذلك الفعل كَلاماً والظاهر به كلمة. وإن توسّط بين الفاعل الحقّ وبين ما يوجَد آلة وجودية أو صورة مظهرية بعينها،ويستدعيها مرتبة المفعول التي هي محلّ إيقاع الفعل ومنزل نفوذ الاقتدار،كانقولاً،لأن التأثير الإلهي في كل مؤثر فيه إنما يصدر ويتعيّن بحسب مرتبة المفعول،وكذلك الآلة والمظهر الذي هو صورة الحيثيّة التي من جهتها صدر ذلك الموجود. والحروف الأصلية الإلهية: عبارة عن تعقّلات الحق الأشياء من حيث كينونتها في وحدانيته،ونظير ذلك التصور النفساني الإنسان قبل تعيّنات صورها بعلمه في ذهنه،وهيتصورات مفردة خالية عن التركيب المعنوي والذهني والحسّي،وهي المفاتيح الأول المعبّر عنها بمفاتيح الغيب،وهي الأسماء الذاتية وأمهات الشؤون الأصلية التي الماهيات هي من لوازمها ونتائج التعقّل تعريفاتها.والتعقّل الثاني: تعقّل الماهيات في عرصة العلم الذاتي من حيث الامتياز النسبي،وهوحضرة الارتسام حيث الأشياء مُرتسمة في نفس الحقّ. والفرق بين الحكيم والمحقق في هذه المسألة هو: أن الارتسام عند المحقق وصف العلم من حيث امتيازه النسبي عن الذات،ليس هو وصف الذات من حيث هي ولا من حيث أن علمها عَينها. فتَعقّل الماهية،من حيث إفرازها عن لوازمها في حضرة العلم،هيحرف غيبي معنوي.وتعقّلها مع لوازمها،قبل انبساط الوجود المُفاض عليها وعلى لوازمها، هي كلمة غيبية معنوية. وباعتبار تعقّل تقدّم اتصال الوجود بها،قبل لوازمها، يكونحرفاً وجودياً. وباعتبار انبساط الوجود عليها وعلى لوازمها الكلية تكون كلمة وجودية.وكما أن تركيب الكلمات في النسخة الإنسانية ينشأ من حرفين وينتهي إلى خمسة،متصلة ومنفصلة ــ وهي: باطن القلب،ثم الصدر،ثم الحَلق، ثم الحَنَك، ثم الشّفتان ــ كذلك للنفَس الرحماني السِراية في هذه الأصول الخمس، وهي نظائر مراتب الأصول،وباقي المخارج يتعيّن بين كل اثنين من هذه الأمهات وهذه الأصول هي: العقل الأول،ثمّ النفوس الفلكية،ثم الأجسام البسيطة،ثم الأجسام المركبة.وقد روعيَ هذا الترتيب الإيجادي في كل كلام إلهي ينزل: حرف، ثم كلمة،ثم آية،ثم سورة،والكتاب جامعها.وأما الكُتب فهي من حيث الأمهات،أيضاً،أربعة كالأجناس: التوراة والإنجيل والزبوروالفرقان، وجامعها القرآن.ولما كانت الحيازة للإنسان لجمعية أحكام الوجوب الكلية والأحكام الإمكانية، سُمّيكتاباً. وتفاوت حيطة الكتب، وماتضمنه،يشهد ويوضح سرّ تفاوت الأمم المنزّلة.
فك ختم الفص الشّيْثي:سرّ اختصاص الحكمة النفثيّة بالكلمة الشيثيّة: لما ثبت أن الحقّ،من حيث صرافة ذاته وإطلاقه،لا يوصف بالمبدئية ولا أنه مصدر لشيء، وأن أول المراتب المتعلّقة: التعيّن الجامع للتعيّنات كلها،وأن له أحدية الجمع،وأنه خصيص بالإنسان الحقيقي الذي آدم صورته. وجَب أن تكون المرتبة التي تليه مرتبة المصدرية الموصوفة بالفياضيّة والمُقتضية للإيجاد،فلزم أن يكون فصّ الحكمة النفثية مخصوصة بالكلمة الشيثية.فمعنى لفظة شيث،في الأصل: عطاء الله. ولأن النّفث عبارة عن انفثاث للنفس الواحد وانبثاثه،وأنه عبارة عن الوجود المنبسط على الماهيات القابلة له والظاهرة به.
سرّ الختمية: العطاء الأسمائي متعقّل الاندراج في ضمن العطاء الذاتي،لقبوله بالذات التعدّد والظهور المتنوع في القوابل وبها،لأن في المقام الإنساني تنختم الدائرة الوجودية وتتّحد الآخرية بالأولية.وللمراتب الختمية كمال الحيطة والاستيعاب، لأن لآخريتها كمال الاستيعاب: معنى وصورة وصفة وحُكماً.. يقول الشيخ الأكبر في آخر هذا الفص: إن آخر مولود يولَد في النوع الإنساني يكون على قدم شيث،وأنه يولد توأماً مع أخت له اهـ ..فأخبر بعموم الحكم الدّوري صورة،كما هو الأمر في المعنى والصفة،وعين الحكم وانتهاء مقدار العطاء في الماهيات والاستعدادات المتناهية القبول. بخلاف القوابل التامة الاستعداد فإن قابلياتها غير متناهية،فلها البقاء السرمدي.وهذا أوجب عدم صعق بعض الموجودات،من الملائكة والأناسي،لكمال الاستعداد القابل للفيض الذاتي على سبيل الاستمرار. ولمن هذا شأنه فله الرّفعة عن مقام النفخ الإسرافيلي،فإن النفخ لا يؤثر في من عَلا عنه،بل في من نزل عن درجته.
فكّ ختم الفص النّوحي:لما كان أول المراتب الإلهية،التي بها ثبت أولية الحقّ ومَبدئيّته،مرتبة أحدية الجمع،كانت صفة الفياضيّة والمصدرية تَليه.. وكان أول القوابل لذلك الفيض الذاتي الإلهية: عالم الأرواح،وهي أتمّ الموجودات طهارة من الكثرة الإمكانية والتركيب والنقائص المكتسبة من الوسائط. ولهذا كان علمها مقصوراً على معرفة الحق،من تجرّده ونزاهته عن الكثرة والتركيب ــ لتضمنها صفة الافتقار ــ فظهرت بصفة التنزيه وانصبغت به. صفة التنزيه: الغالب على حال نوح صفة التنزيه،لأنه مبدأ ظهور الرسالة وأول قابل لحُكمها،وأول مُطالب للخلق بالتوحيد المشار إليه. فيه ظهرت أوليّة عالم الأرواح وصفتها القابلة أول الفيض الإلهي الوحداني،والظاهرة بحكمه وصفته. ولهذا غلب عليه حال الغيرة والغضب على قومه،لمّا شاهد انعكافهم على عبادة الأصنام،حتى دعا عليهم بالهلاك.. فافهم هذا،تعرف سرّ الحكمة السبوحيّة واختصاصه بنوح عليه السلام..
فك ختم الفص الإدريسي:ذكر الشيخ الأكبر إدريس بعد نوح،لاشتراك واقع بينهما،من حيث إن الصفة القدوسية تلي الصفة السبوحية في المعنى والمرتبة. فإن السبّوح هو المُبرّئ والمنزّه عن أن يلُمّ به النقص،والقدوس هو الطاهر المقدّس عمّا يتوهّم فيه من إمكان تطرّق ما إليه يُشينه..وسرّ اختصاص هذه الصفة بإدريس فلأجل أن الكمال الذي حصل له إنما كان بطريق التقديس، وهوتروحُنه وانسلاخه عن الكدورات الطبيعية والنقائص العارضة له من المزاج العنصري.ولما قيل فيه إنه:رفع مكاناً علياً،والعلوّ على قسمين: علو مكان وعلو مكانة. وأخبر الحق أنه مع كل شيء،والأشياء لا تخلو عن أحد العلوين، فوجب من هذا أن يكون الحق منزّهاً عنهما نَفياً للاشتراك.. والسرّ فيه: الحقّ في كل متعيّن غير متعيّن،فكما تنتفي عنه الإشارة الحسيّة،كذلك تنتفي عنه الإشارة العقلية. فتقدّس عمّا يتوهّم فيه من الاشتراك بسبب المفهوم من المعية وبسبب المفهوم من علو المكانة.
فك ختم الفص الإبراهيمي:إنما قرن الحكمة المُهَيّميّة بالكلمة الإبراهيمية،من أجل أن صفة التهيّم تقتضي عدم الانحياز إلى جهة تُعيّنها وعدم امتياز صاحبها بصفة مخصوصة تُقيّده. وهذا هو مقام الخُلّة الأولى الحاصلة من عدم ارتفاع الحجب،بخلاف الخلّة الأخرى الخاصة بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم..الخلّة الإبراهيمية: لها أوليّة الظهور بالصفات الإلهية الثبوتية،بمعنى أنه بحقيقته كَسى الذات بالصفات،ولهذه المناسبة ورد في الصحيح: إن أول من يُكسى من الخلق يوم القيامة إبراهيم اهـ.. وله ظاهرية البرزخيةالأولى،وهو أول من كمُلت به كليات أحكام الوجوب في مرتبة الإمكان، وهي الكلمات التي أتمّهنّ،فجيء عقب إتمامها بالإمامة على الناس.والخلّة الخاصّة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا حجاب معها،لأن مقتضى الأولى مُقابلة تعيّنات خصوصة من تعيّنات الحق المعبّر عنها بالصفات وبقابليات ذاتية بها غيرية هي لوازم حقيقة القابل. بخلاف خلّة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن المقابلة فيها واقعة بين صفات ظاهرية الحق وبين صفات باطنية،مع أحدية العين التي هي الهوية الموصوفة بالظهور والبطون..فالأمر،من حيث الحقّ،أمر واحد لا كثرة فيه. والكثرة المتعلّقة في الأسماء والعَطايا مُنتشأة من القوابل..لما بدأ الشيخ الأكبر بذكر السبوحية،ثمّ القدوسية،وجب أن يذكر بعد صفات التنزيه السلبية أحكام الصفات الثبوتية ومراتبها وأول مظاهرها الإنسانية لتكميل مرتبة المعرفة بالذات،فإنالسلوب لا تُفيد معرفة تامة أصلاً.فكان الخليل أول مرآة ظهرت بها أحكام الصفات الإلهية الثبوتية،وأول من حاز التخلّق بها،وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم التحقّق بها. والفرق بين التخلّق والتحقّق هو: أن التخلّق يحصُل بالكسب والتعمّل في التجلّي بها،فيكون صاحب التخلق مَحلاً لأحكامها وهدفاً لسِهام آثارها. والتحقّق لا يصحّ إلا بمناسبة ذاتية تقتضي بأن يكون المتحقق بها مرآة للذات. والمرتبة الجامعة للصفات ترسُم فيه جميع الأسماء والصفات،ارتساماً ذاتياً لا على سبيل المحاكاة للارتسام الإلهي فيه،أعني بصاحب التحقق يظهر وينفُذ آثار الصفات والأسماء في المُتخلّقين بها وغيرهم من المجالي الذين هم محال آثارهم من الأناسي وغيرهم..
فك ختم الفص الإسحاقي:اعلم أن شيخنا لم يلزم في هذا الكتاب مُراعاة الترتيب الوجودي في شأن الأنبياء المذكورين، وإن وقع كثير من ذلك مُطابقاً للترتيب المشار إليه،بل إنما التزَم التنبيه على المناسبة الثابتة بين النبي وبين الصفة التي قرنها به،والإشارة إلى محتدّ ذوق ذلك النبي ومُستنده من الحق.. عالَم الخيال: الفص الإسحاقي مَحتدّه عالَم الخيال الصحيح،المطابق والمناسب للمعنى الذي يتجسّد به وفيه. والسرّ في استناد مبدئية حال إسحاق إلى عالم المثال المقيّد هو أنه: لما كان أخصّ أحكام الصفات السلبية سَلب الكثرة عن وحدة الحق،كانت الموجودات الصادرة عن الحق من حيث الصفات السلبية التنزيهية أقربها نسبة إلى الوحدة وأبعدها من مرتبة الظهور،وهيالأرواح،بخلاف الصفات الثبوتية فإنه يجب أن تكون الموجودات الصادرة عن الحق من حيثُها أقرب نسبة إلى الظهور وأتمّ تحقّقاً به.وقد بينّا أن أول حامل وظاهر بأحكام الصفات الثبوتية الخليل عليه السلام،فلزم أن يظهر في حال ولده الذي هو النتيجة حُكم عالم الخيال وصفته، لأن عالَم المثال المطلق مرتبته عالَم الأرواح وعالم الأجسام..فسرّ سفر التجلّي الوجودي الغيبي من غيب الهوية الإلهية،طلباً لكمال الجلاء والاستجلاء: وأول منازله عالَم المعاني. ويليه عالَم الأرواح،وظهور الوجود فيه أتمّ منه في عالم المعاني. ويليه عالَم المثال،وهو المنزل الثالث،وظهور الوجود فيه أتمّ منه في عالم الأرواح. ويليه عالم الحسّ،وهو المنزل الرابع،وفيه تَمّ ظهور الوجود. ولهذا كان العرش،الذي هو أول الصور المحسوسة والمحيط بها،مقام الاستواء الرحماني،فإن عنده تمّ ظهور التجلّي الوجودي واستقرّ.. ولعالم الخيال مرتبتان واسمان: مرتبة مقيّدة تختصّ بالإنسان وبكل متخيّل،ويُسمّى باعتبار تقييده خَيالاً،وانطباع المعاني والأرواح فيه قد يكون مطابقاً وقد يكون غير مطابق.. وهذا العالم في مرتبة إطلاقه يُسمى عالم المثال،وكل ما يتجسّد فيه يكون مطابقاً لا محالة،فإذا صحّت المطابقة في الخيال المقيّد كان حقّاً لشَبَهه بعالم المثال.. ولهذا ترجَم الشيخ هذا الفصّ بالحكمة الحَقيّة..
فك ختم الفص الإسماعيلي:اعلم أن متعلّق هذا الفص ومرجعه إلى صفتين: صفة العلو وصفة الرضا. ومحتدّه من الجناب الإلهي نسبتان: الوحدة الذاتية والجمعية الأسمائية.فأما سرّ اختصاص إسماعيل بالعلو: فهو من وجه بالنسبة إلى بقيّة أولاد الخليل من أجل أنه كان كالوعاء لسرّ الكمال المحمدي الذي نسبته إلى ذات الحقّ أتمّ،كما أن إسحاق وعاء لأسرار الأسماء التي كان الأنبياء مظاهرها.كل نبيّ هو مظهر اسم من الأسماء.. وانفرد إسماعيل بنبينا صلى الله عليه وسلم الجامع لخواص الأسماء بشريعة جامعة لأحكام الشرائع،وهذا هو الموجب لقول الشيخ الأكبر في أول الفص: اعلم أن مُسمّى الله أحديّ بالذات،كُلّ بالأسماء اهـ ،وذكر أن أحديته مجموع كلّه بالقوة.وليُعلم أنه لولا أن الله سبحانه أنْعَم بمشاركتي الشيخ في أصل الذّوق ومحتدّه،لم يكن معرفة مقصوده من فحوى كلامه. لكن متى حصل الاطّلاع على أصل الذوق ومشرعه،عرف المقصود من فحوى كلامه..البيت المعمور مَحلّ نظر الحقّ ومُسمّى الربّ،كما أن العرش مستوى اسم الرحمن،وأن الكرسي مستوى اسم الرحيم،والسماء السادسة مستوى الاسم العليم،والخامسة مستوى الاسم المُصوّر، والثانية مستوى الاسم البارئ،والأولى مستوى الاسم الخالق. وأما قلب الإنسان الكامل الحقيقي فهو مستوى الاسم الله الذي هو للذات..أول لازم متعيّن من الذات هو علم الحق من حيث امتيازه النسبي ــ لا من حيث إن علمه عين ذاته،ولا من حيث إنه صفة زائدة على الذات ــ وهذا التعيّن العلمي هو تعيّن جامع للتعيّنات كلها المعبّر عنها بالأسماء والأعيان. فالأشياء مُرتسمة فيها،أعني في هذه النسبة العلمية،وتتعلّق بالمعلومات بحسب ما هي المعلومات عليه في أنفسها..والله لقد ظهر لي يومي هذا من العلوم والأسرار ما لو شرعت في تفصيل كلياته لما وفّت ببيانه مجلدات كثيرة،فاعرف ما أسّست في هذا الفصل من الأسرار تستشرف على علوم جمّة،من جملتها بُعد غور شيخنا: كيف شرع في أول الفص بذكر الوحدة الذاتية والجمعية الأسمائية، وذكر معنى الإيجاد وتوقّفه بعد العلم على القبول والاقتدار،هذا إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر من العلوم..
فك ختم الفص اليعقوبي: اعلم أن إقران الشيخ هذا الفص بالصفة الروحية وبناء الكلام فيه على ذكر الدين وأحكامه،أسرار عظيمة..فالسرّ الواحد الجامع بين الصفة الروحية والدين هو: التدبير،وهو على قسمين: ذاتي،وكسبي تعمّلي. والنسخة الإنسانية مشتملة على التدبيرين،وبهما بقاء الإنسان وصلاح حاله عاجلاً وآجلاً. الذاتي: هو كتدبير الطبيعة المزاجية بموجب ما يشتمل عليه من القوى الذاتية والقوى المستفادة من العالم العلوي الحاصلة في طبيعة مزاج الإنسان.. والتدبير الكسبي: تدبير الروح،وهو على قسمين: تدبيره العقلي طلباً للاستكمال والتخلّق بأخلاق الله والتجلّي بصفاته وقصد التشبّه بجنابه، دون التهمّم بأحوال المزاج وتدفّق النظر في مراعاة مصالحه. والقسم الآخر من التدبير للبدن والنظر لمصالحه،وهو تدبير جامع بين التدبيرين:الروحي والطبيعي.. والسرّ الآخر في إقران الصفة الروحية بيعقوب: هو أن يعقوب كالمظهر والمثال للفلك الأول المسمّى بالعرش، فهوأول صورة جسمية دبّرها روح،فناسَب ذكر الصفة الروحية هاهنا وأقرانها بيعقوب.. كل ما ذكره الشيخ من أسرار الأنبياء ومحتدّ أحوالهم،من أول الكتاب إلى هنا،راعى فيه التنبيه على سرّ أوليّة كل مرتبة من مراتبهم.. فحقّ لنا أن نبّهنا على سرّ الصفة الروحية واختصاصها من حيث الإضافة بيعقوب عليه السلام.. المُجازاة بالمُوافق والمخالف: اعلم أن المُجازاة الأولى الكليّة تعيّنت باعتبار الرحمة العامة الإيجادية التي وسعت كل شيء بمطلق قابلية الممكنات المخلوقة، وقيامها مقام المَرايا لظهور الوجود فيها،وظهور آثاره وتنوعاته وظهوراته بها، ومن حيث إنها لما كانت شرطاً في ظهور أحكام الأسماء وتعيّناتها عوضت بالتجلّي الوجودي الذاتي الذي ظهر به عينها لها ونفذ حُكم بعضها في البعض، فظهر بذلك أيضاً شرف بعضها على البعض بمزيد الاستعداد وقبول الوجود على وجه أتمّ ووضوح حجة الحق على القوابل الناقصة والموجودات الموصوفة بالشقاء،إذ ذلك لم يوجبه الحق عليها من حيث هو،بل ذلك منها لا من سواها. والذي للحق إظهارها بالتجلّي الوجودي على نحو ما علمها،وهذا السرّ هو مفتاح سرّ القضاء والقدر أيضاً،فاعلم ذلك. فهذا أصل المجازاة بالموافق.وأما أصل المجازاة بما لا يُوافق: فذلك راجع إلى القيود والتغيّر العارض للتجلّي الوجودي من القوابل وحُسن المُواتاة لما يراد من القابل وعدمه،فالتكليفات من مقابلة تلك التقيّدات الغير المرضية. ففي أي قابل تَقلّ القيود والتغيرات في التجلّي المقبول وظهرت فيه مواتاةمرضية،كان تكليفه أقلّ وكان ما لا مندوحة عنه من التقيّدات مما هو ضروري الوقوع معفُواً عنه ومغفوراً لصاحبه ومُستهلك الحُكم في جنب باقي الصفات والأحكام التي ظهر القابل بها على الوجه المراد.فافهم هذا فإنه من أغمض العلوم، عَلم سرّه عَلم سرّ الوجوب والتكليف، وسرّ الإباحة والتقييد المسمى بالمحرّم والحلال المطلق،والعفو والمغفرة، وسبب الشقاء والسعادة. وسرّ عدم تكليف الصغار من الأناسي، وعدم تكليف الحيوانات،وأن ذلك راجع إلى المُطاوعة الذاتية والانقياد بالطبع والظهور بما أريد منه. بخلاف الإنسان،فإنه ادّعى بحاله من حيث قابليته الصورة الإنسانية أن يكون مرآة لحقيقتها تماماً،بحيث يظهر أحكامها بالفعل،فقوبلَ بالامتحان مقابلة ذاتية بموازنة حقيقة عدلية..
فك ختم الفص اليوسفي:هذا الفص مُضاف إلى الصفة النورية.. النور المطلق، والظلمة، والضيّاء: اعلم أن النور الحقيقي يُدرك به وهو لا يُدرك،لأنه عين ذات الحق من حيث تجرّدها عن النّسب والإضافات.. واعلم أن الظلمة لا تُدرَك ولا يُدرك بها،وأنالضياء يدرَك ويُدرك به [ محتدّ الضيّاء هو عالَم المِثال ].ولكل واحد من الثلاثة شرف يختص به: فشرف النور الحقيقي هو من حيث الأولية والأصالة،إذ هو سبب انكشاف كل مستور. وشرف الظلمة هو أنه باتّصال النور الحقيقي بها يتأتّى إدراك النور ــ مع تعذّر ذلك قبل الاتصال. وشرف الضياء هو من حيث الجمع بالذات بين الأمرين، واستلزام ذلك حيازة الشرفين.وللنور الحقيقي ثلاث مراتب أخر: إحداها مشاركة للوجود المحض المطلق،والأخرى مشاركة للعلم الحقيقي المطلق أيضاً،والثالثة اختصاصه بالجمع الذي له الظهور والإظهار.فأما وجه اتّحاد العلم مع الوجود والنور،فهو من جهة أن كُلاً منها من شأنه كشف المستور. أما الكشف بالوجود فهو من جهة أن الوجود لَمّا كان واحداً في الأصل،وعرضت له التعدادات المختلفة،عَلم أن ثَمّ معدودات متفاوتة القبول،فصار الوجود من هذا الوجه سبباً لمعرفة الماهيات المعدومة،إذ لولاه لم يعلم أن ثمّة ماهيات أصلاً. وأما العلم فيكشف الماهيات المعدومة قبل الكشف الوجودي، ويعرف بكيفية قبولها للوجود وتوابع ذلك من بقاء وفناء وبساطة وتركيب وغير ذلك من اللوازم. وأما كشف النور فهو متأخّر عن الكشف الوجودي،لكنه يشترك الوجود والعلم في معقولية الكشف. فافهم.واعلم أن كل واحد،من الوجود والعلم والنور،لا يتميّز بينهم في أن كل واحد من حيث وحدته وإطلاقه لا يُدرك ولا يُرى،بل تعدّد بينهم في حضرة الأحدية الذاتية. ويتميّز الوجود عن العلم بكون المعلومات تُعدّد العلم من حيث التعلقات في مرتبة التعقّل لا غير ــ بخلاف الوجود ــ فإن الموجودات تُعدّده وتُظهره للمدارك في المراتب التفصيلية.وأما الفرق بين النور الحقيقي ومُسمّى الوجود المحض فهو من جهة أن الوجود يَظهر للمدارك بقابلية المعلومات المعدومة المُتعيّنة في علم الحق، والنور المحض لا يمكن إدراكه إلا في مظهر موجود.فاعلم ذلك وتدبّره تَعرف الفرق: بين الحقائق،وهي الماهيات الأسماء الإلهية،وبماذا يتميّز بعضها عن بعض، والفرق بين حُكم الوجود وحُكم العلم وحُكم النور،وشأن كل واحد منهم مع الآخر، وشأن الثلاثة مع غيرهم من التوابع واللوازم،والأسماء متفرعة عنهم.ألا ترى أنه لما كان عالم الأرواح،وما فوقه من عوالم الأسماء والصفات، موصوفاً بالنور والوجود الأبدي،كانت صور عالم الكون والفساد موصوفة بالكدورة والظلمة؟ لكونها في مقابلة عالم الأرواح الذي هو عالم النور. ولهذا لقّب شيخنا هذه الحكمة بالنوريّة،وإلا فهي حقيقة ضِيّائيّة لا نورية محضة.وأما المتوسط بين نشأة الإنسان العنصرية وبين الروحانية معناه: فهو عالم الخيال المقيّد،والصورة الظاهرة فيه تكون بحسب نسبة ذي الخيال المقيّد من الطرفين: فإن قويت نسبته إلى طرق الأرواح وما فوقها،كانت تخيلاته صحيحة حقيّة وجودية علمية نورانية. وإن قويت نسبته إلى عالم الحسّ،لغلبة أحكام صورها المنحرفة الفاسدة وأحوالها المختلفة البعيدة عن الاعتدال،كانت تخيلاته ــ يقظة ومناماً ــ تخيلات فاسدة وآراؤه واعتقاداته غير صائبة،لخُلوها عن النور العلمي وخاصية الوجود الأبدي،فسُمّيت أضغاث أحلام.. سِرّ كَوْن الحقّ خلاّقاً على الدّوام: الحق هو النور،والنور لا يمكن أن يُرى في النور،فكمال رؤية النور موقوف على مقابلة الظلمة.فمتعلّق حُبّ الحقّ إيجاد العالَم،إنما موجبه حُبّ كمال رؤية الحق نفسه جُملة،من حيث هويته ووحدَته، وتفصيلاً من حيث ظهوره في شؤونه. ولما كان من البيّن أن كل ما لا يحصُل المطلوب إلا به فهو مطلوب،لَزم تعلّق الإرادة الإلهية بإيجاد العالَم لتوقّف حصول المطلوب الذي هو عبارة عن كمال الجلاء والاستجلاء عليه.ولما كانت الشؤون الإلهية ذاتية،وكان الاستجلاء التام للذات لا يحصُل إلا بالظهور في كل شأن منها بحسبه ورؤيته نفسه من حيث ذلك الشأن وبمقدار ما يقبله من إطلاقه وتعيّنه وخصوصيته ــ فتوقّف كمال رؤيته على ظهوره في جميع الشؤون. ولما كانت الشؤون مختلفة من حيث خصوصياتها وغير منحصرة،وجَب دوام تنوعات ظهوراته سبحانه بحسبها.. وهذا هو سِرّ كون الحق خَلاّقاً على الدوام إلى أبد الآباد.. شرف الرؤية عند الشيخ الأكبر،العلم تابع للمعلوم: وأما ما شاهدته وذُقته وجرّبته من ذوق شيخنا فأعظم وأعلى من أن يتسلّق الفهوم إليه أو يستشرف العقول عليه،فإنه كان يستجلي المعلومات الإلهية في حضرة العلم ويُخبر عن كيفية تبعية العلم للمعلوم،وكون العلم لا أثر له في المعلوم،بل المعلوم يُعيّن تعلّق علم العالِم به ويُعطيه ذلك من ذاته.. وكان يشهد الاستعدادات التي للناس، جزئياتها وكلياتها،ويَشهد نتائجها،وما يستمرّ كل استعداد منها إلى منتهى أمر كل إنسان في مرتبة شقائه وسعادته. وكان إخباره عنه تابعاً لنظرة مخصوصة ينظُر بها إلى الشخص،أي شخص أراد الاستشراف على كُنه حاله وما يستقبله إلى حين مُستقرّه في مآله في مرتبة نقصه أو كماله،ثمّ يُخبر ولا يُخطئ.شاهدت ذلك منه في غير واحد وفي غير قضية،من الأمور الإلهية والكونية. واطّلعت،بعد فضل الله وببركته،على سِرّ القدر ومحتدّ الحُكم الإلهي على أشياء،وبشّرني بالإصابة في الحكم بعد ذلك في ما أحكُم به بسبب هذا الاطّلاع ونيل ما يتعلّق الإرداة بوقوعه بموجب هذا الكشف الأعلى،فلم ينخرم الأمر عليّ ولم ينفسخ. والحمد لله المنعم المفضل..
فكّ ختم الفصّ الهودي:
مراتب الوحدة: للوحدة ثلاث مراتب،لكل مرتبة اعتبار: الاعتبار الأول: اعتبار الوحدة من حيث هي هي،هذا الوجه لا تُغاير الأحدية،بل هي عينها لا من الوجهين الآخرين. وليست من هذا الوجده نعتاً للواحد،بل هي ذاته. فمتى ذكرت الأحدية الذاتية،وكان المترجم عنها الحق أو واحد من أكابر المحققين الراسخين في العلم،فإنه إنما يطلقها بهذا الاعتبار الذي ذكرناه. ولكل شيء أحدية تخصّه، وهي اعتباره من حيث عدم مغايرة كل شأن من الشؤون الذاتية للذات المُعنونة بالأحدية بالتفسير المشار إليه.الاعتبار الثاني: اعتبار الوحدة من كونها نعتاً للواحد،وتُسمّى بوحدة النّسب.. ويُنضاف إلى الحق من حيث الاسم الله الذي هو محتدّ الأسماء والصفات، ومشرع الوحدة والكثرة المعلومتين للجمهور.الاعتبار الثالث: اعتبار الوحدة من حيث ما يلحقها من الأحكام التي هي على نوعين: نوع متعقّل فيها،لكن ظهوره موقوف على شرط أو شروط،مع أن تلك الوحدة بالذات مشتملة عليها بالقوة. والنوع الثاني من النعوت والأحكام ليست الوحدة بالذات مشتملة عليها،وإنما يلحق وينضاف إليها من أمور خارجة عن معقولية صرافة وحدتها،كقولنا: الواحد نصف الاثنين.. والوحدة التي تُضادّها الكثرة،وتختصّ بمرتبة الأفعال،لوحدة الفعل والفاعل، وكثرة المَحالّ التي بها تظهر الكثرة ــ فإنها الخصيصة بهذا الفصّ الهودي،وهو ذوق هود،فإنه ذكر الأخذ بالنواصي والمشي والصراط،وكل هذه أحكام التصرف والتصريف وأنه الفعل لا محالة.. مشاهد الوحدة والأسباب: غير أنه غلب في أخباره وحدة الفعل على التعدادات العارضة له في المحال المتأثرة والمعددة إيّاه. والسرّ فيه هو من أجل عدم اعتبار الوسائط والأسباب المشار إليها بقوله تعالى: (ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها) فأضاف الأخذ إلى الهوية التي هي عين الذات،حتى أنه لم يذكر يَداً ولا صفة ولا غير ذلك.وهو مَشهد المتوسطين من المحققين،فإن مقتضى ذوقهم أن الأسباب والوسائط معدّات لا مؤثرات. وأن الفعل في أصله واحد وأنه أثر الحق،لا أثر فيه لسواه من حيث ذات الفعل من كونه فعلاً،لكن يكتسب ذلك الفعل الوحداني فعل المتعدّدات من المحالّ المتأثرة. ويتبع ذلك التعدد كيفيات نافعة للمكتسب العدد، وكيفيات مُضرّة له عاجلاً وآجلاً. وذلك النفع والضرّ: تارة يعودان على الإنسان من حيث روحه،وتارة يعودان عليه من حيث صورته ونشأته،وتارة يعودان على المجموع.وثَمّ صنف أعلى وأكْشَف من هذا الصنف،ومقتضى ذوقهم: أن الفعل الوحداني،وإن كان إلهياً ومطلقاً في الأصل،لا وصف له غير تعيّنه بالتأثير. والتأثير التكليفي إنما يكون بحسب المراتب التي يحصل فيها اجتماع جملة من أحكام الوجوب والإمكان في قابل لها وجامع. فإن ظهرت الغلبة لأحكام الوجوب على أحكام الإمكان وصف الفعل،بعد تقيّده وقبوله التعدّد،طاعة وفعلاً مرضياً حميداً. وأن كانت الغلبة لأحكام الإمكان،وتضاعف الخواص الوسائط،كان الأمر بالعكس،بمعنى أن الفعل يُسمّى من حيث تقيّده على ذلك الوجه وتكيّفه بتلك الكيفيات معصية وفعلاً قبيحاً ونحو ذلك..والحُسن والقُبح راجعان إلى ما يناسب مرتبة الشرع والعقل،وإلى الملاءمة من حيث الطبع والغرض..وثَمّ صنف أعلى،ومن مقتضى ذوقهم وشُهودهم: معرفة أن كل سبب وشرط ووسائط ليس غير تعيّن من تعيّنات الحق،وأنه فعله تعالى الوحداني يعود إليه من حيثية كل تعيّن بحسب الأمر المقتضى للتعيّن،كان ما كان. وأن المضاف إليه ذلك الفعل ظاهراً يتّصل به حُكم الفعل وثمرته بحسب شهوده معرفته ونسبته إلى الفعل الأصلي وأحدية التصرّف والمُتصرّف،وانصباغ أفعاله بحكم الوجوب وسرّ سَبق العلم وموجبه ومقتضاه..ومن لم يذق هذا المشهد ولم يطّلع عليه،لم يعرف سر قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)،ولا سر قوله تعالى: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله)،ولا سرّ قوله تعالى: (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم)،ولا سر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده اهـ،ولا سر قوله تعالى: كنت سمعه وبصره ويده ورجله اهـ الحديث. ولا يعرف من أي وجه يصحّ نسبة الأفعال إلى الحق من حيث أصالتها ومن حيث أحدية جمعها،ومن أي وجه أيضاً يصحّ نسبتها إلى الحق وإن تعدّدت وتكثّرت..
فك ختم الفص الصالحي:بسط الشيخ الكلام،في هذا الفصّ،عن سِرّ الإيجاد وتوقيفه على التثليث.. فقد ترجَم الشيخ هذا الفصّ بالحكمة الفتوحية،وكذلك نبّه على سرّ الإيجاد الذي هو أول الفتح الظاهر.. أنواع الفتوح: الفتوح على أنواع،عددها عدَد مفاتيح الغيب.. فراعى الشيخ في ذلك الأدب الإلهي قصد الموافقة للحق في التنبيه على البدء الإيجادي من الغيب الذاتي والوجود المطلق الإحاطي..أول مفاتيح الغيب: الجمع الأحدي،الذي هو البرزخ الجامع بين أحكام الوجوب والإمكان. فإن الوحدة الذاتية والتجلّي الوجودي الإطلاقي لا يُضاف إليهما اعتبار من الاعتبارات الثبوتية والسلبية ــ كالاقتضاء الإيجادي أو نفيه ــ ولا الأثر الوحداني أيضاً ولا التعدّد وكيف ذلك؟ والتحقيق أفاد أن تأثير كل مؤثر في كل متأثر موقوف على الارتباط،ولا ارتباط بين شيئين أو الأشياء إلا بمناسبة أو أمر مشترك بينهما،ولا ارتباط بين الأحدية الذاتية من حيث تجرّدها عن الاعتبارات وبين شيء أصلاً..فمبدئية الحق ونسبة صدور شيء أو أشياء عنه إنما يصحّ من حيث الواحدية،والواحدية تلي الأحدية، وهي مشرع الصفات والأسماء التي لها الكثرة النسبية،فإنها من حيث الحق الواحد حيثيات أو اعتبارات.. ولما كان في مقابلة كل تأثير قابل له مُتأثّر،سُمّيت تلك القابليات بأحكام الإمكان..وإذا تقرّر هذا فاعلم: إن أول المفاتيح الغيبية،بعد الجمع الأحديّ،الأسماء الذاتية التي لا يعلمها إلا الكمّل،وهي من أعظم أسرار الحقّ المحرّم إفشائها. وأمهات الأسماء الألوهية ــ التي هي: العلم والحياة والإرادة والقدرة ــ كالظلالات والسّدنة للأسماء الذاتية. ولهذه الأسماء الذاتية الغيب الحقيقي،وهي السارية بالذات والحُكم في المفاتيح التي تختص بالغيب الإضافيّ،وهي التي كَنّى الحق عنها بـ: الفَطْر والفتق والزرع والخلق والجعل والإخراج.الفطر والفتق: مفتاحان لتميّز المواد الجامعة بذاتها بين اللطائف والكثائف والصلبة والرخوة، أحدهما لتكثير الواحد والآخر لتفصيل المجمل. والزرع والفلق: مفتاحان للإظهار والتوليد والتكوين،أحدهما لتهيئة المادة لقبول التصريف والآخر لتكميل التصريف بإخراج ما في القوة إلى الفعل. والخلق: مفتاح مختصّ بالصور والأجسام،من حيث الجمع والتركيب والتعيين. وأما الإخراج: فعلى ضربين: إخراج منه كالمطر من السحاب والمعادن من جوف الأرض والجبل والمياه،وإخراج كالمطر يخرج به النبات من الأرض،وكل هذا مفاتيح. وأما الجعل: فإنه مفتاح إيجاد الصفات اللاّزمة للمخلوقات والخصيص بالحقّ..وأما مفتاح الإيجاد الأمري: الذي نتيجته وجود الأرواح فهو القول،فإنه نتيجة اجتماع بعض الحروف الربانية..وأما سِرّ إيجاد عالَم المعاني: فإنه نتيجة التوجّه الأول الذاتي من حيث روح الجمع الأحدي،فافهم.
فك ختم الفص الشُعَيْبي:في إقران شيخنا الحكمة القلبية بالكلمة الشعيبيّة سِرّين عظيمين: أحدهما: راعى فيه المفهوم من لفظ الاسم،وهوالشعيب.. ولما كان القلب منبع التشعّب لذلك تنبعث منه الحياة الحيوانية وتسري في جميع أقطار الصورة، فيتّصل به ومنه إلى الأعضاء كلها المدَد الذي به بقاء الصورة..والسرّ الآخر: يختصّ بسِعَة القلب ونَسبه من الرحمة التي وسعت كل شيء،وتشعّبت مائة شعبة.. برزخيّة الإنسان الكامل: وأما قلب جُملة الصورة الوجودية: فالإنسان الكامل الحقيقي برزخ بين الوجوب والإمكان،والمرآة الجامعة للذات والمرتبة من صفات القدم وأحكامه، وكذلك الحدثان،ولهذا جعل محلّ خلافته الأرض التي هي مركز الدائرة الوجودية،ولمقامها المعنوي المحجوب الآن بصورتها رُتبة المبدائيّة في انبعاث النفَس الرحماني لتكوين النشأة الكلية الوجودية. فناسَب،من هذا الوجه، الإنسان الحقيقي النازل فيها بالخلافة،لأنه الأول بالرّتبة والمنزلة،وإن كان آخراً بالصورة. فهو الواسطة بين الحق والخلق،وبِه ومن مرتبته يصل فيض الحق والمدد الذي هو سبب بقاء ما سوى الله إلى العالَم كله علواً وسُفلاً. ولولاه،من حيث برزخيته التي تُغاير الطرفين،لم يقبل شيء من العالم المدد الإلهي الوحداني، لعدم المناسبة والارتباط،ولم يصل إليه..ولهذا السرّ،برحلته من مركز الأرض ــ التي هي صورة حضرة الجمع وأحديته ومنزل خلافته الإلهية إلى الكرسي الكريم والعرش المجيد المحيطين بالسماوات والأرض ــ ينخرم نظامها، فيُبدّل الأرض والسماوات.. ولا تقوم الساعة وفي الأرض إنسان كامل،وهو المُشار إليه بأنه العمَد المعنوي الماسِك،وإن شئت فقُل: الممسوك لأجله..ولولا ثبوته،من حيث مظهريته في الجنة التي محلها الكرسي والعرش المجيد،لكان الحال فيهما كالحال في الأرض والسماوات. وإنما قيّدت ثبوته من حيث مظهريته،من أجل ما أطلعني الله عليه من أن الجنة لا تَسع إنساناً كاملاً، وإنمايكون منه في الجنة ما يناسب الجنة وفي كل عالَم ما يناسب ذلك العالم وما يستدعيه ذلك العالم من الحق من حيث ما في ذلك العالم من الإنسان.بل أقول: ولو خلَت جهنم منه لم تَبْق،وبه امتلأت وإليه الإشارة بقدم الجبار المذكور في الحديث.. وأخبرت من جانب الحقّ أن القدَم الموضوع في جهنم هو الباقي في هذا العالَم من صور الكُمّل ممّا لم يصحبهم في النشأة الجنانية،وكُنّيَ عن ذلك الباقي بالقَدم لمناسبة شريفة لطيفة،فإن القدم من الإنسان آخر أعضاء صورته، فكذلك نفس صورته العنصرية آخر أعضاء مطلق الصورة الإنسانية،لأن العالم بأجمعها كالأعضاء لمطلق صورته الحقيقية الإنسانية،وهذه النشأة آخر صورة ظهرت بها الحقيقة الإنسانية وبها قامت الصور كلها التي قُلت إنها كالأعضاء.. مراتب القلب: للقلب خمس مراتب: مرتبة معنوية،ومرتبة روحانية،ومرتبة مثالية، ومرتبة حسيّة،ومرتبة جامعة. ولكل مرتبة من هذه المراتب الخمس مَظهر هو منبع أحكام تلك المرتبة ومحتدّ التشعّب المُتفرّع منها.ولكل قلب،أيضاً،خمسة أوجه: وجه يُواجه حضرة الحق ولا واسطة بينه وبين الحق،ووجه يُقابل به عالَم الأرواح ومن جهته يأخذ من ربّه ما يقتضيه استعداده بواسطة الأرواح،ووجهيختصّ لعالَم المثال ويحتظي منه بمقدار نسبته من مقام الجمع وبحسب اعتدال مزاجه وأخلاقه وانتظام أحواله في تصرفاته وتصوراته وحضوره ومعرفته،ووجه يَلي عالم الشهادة ويختصّ بالاسم الظاهر والآخر،ووجه جامع يختصّ بأحدية الجمع وهي التي تلي مرتبة الهوية المعنوية بالأولية والآخرية والبطون والظهور والجمع بين هذه النعوت الأربعة. ولكل وجه مظهر من الأناسي،والخصيص لشعيب عليه السلام من هذه الوجوه: الوجه المثالي،وأنه من وجه في مقامه هذا شبيه بالروح الحيواني المخزون في تجويف الأيسر من القلب الصنوبري،فإنه برزخ بين الروح الإنسان وبين المزاج: لأنه من حيث إنه قوة بسيطة معقولة يُناسب الروح ويرتبط به،ومن حيث اشتماله بالذات على القوى المختلفة المُنبثّة في أقطار البدن والمتصرّف فيه بالتصرفات المختلفة المتكثّرة،يُناسب المزاج المركّب من الأجزاء والطبائع المختلفة.. ولما كانت التصورات المثالية من الثمرة للصورة الحسيّة الظاهرة، كانت تربية موسى عليه السلام ــ أوّلاً ــ على يد شعيب،ولذلك كان الغالب على حال موسى وآياته أحكام الاسم الظاهر. ولما شاء الحق تكميله ــ لكونه اصطنعه لنفسه ــ لذلك أرسله إلى الخضر الذي هو مظهر الاسم الباطن وصورة الوجه القلبي الذي يلي الحق.. السّعة: الرحمة والقلب والعلم: أعظم الأشياء الموصوفة بالسّعة من جانب الحقّ: الرحمة والقلب الإنساني والعلم. فإنه قال في سعة الرحمة: (ورحمتي وسعت كل شيء)،وقال في الرحمة والعلم معاً بلسان الملائكة: (ربّنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً)،وقال في سعة القلب الإنساني: ما وسعني أرضي ولا سمائي،ووسعني قلب عبدي المؤمن اهـ الحديث.ولا شكّ أن بين سعة كل واحد من هذه الثلاثة وبين الآخرين تفاوُتاً لا يُعرف معرفة حقيقية ما لَم يعرف: حقيقة الرحمة وأحكامهاوحقيقة العلم وكيفية تعلّقه بالمعلومات،وحقيقة القلب الذي وسع الحقّ. وأما سعة القلب الذي وسع الحق: فهي عبارة عن سعة البرزخية الخصيصة بالإنسان الحقيقي الذي هو قلب الجمع والوجود..
فكّ ختم الفصّ اللّوطيّ:قَرن شيخنا هذه الحكمة بالصفة الملكيّة مُراعاة للأمر الغالب على حال لوط عليه السلام وأمته،وما عامل الحق به قومه من شدّة العقوبة في مُقابلة الشدّة التي قاساها لوط منهم حتى نطق لسان حاله معهم بقوله تعالى: (لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد).. العقوبات الإلهية: اعلم أن العقوبات الإلهية كلّها مُجازاة،لا يقع منها شيء إبتداءً أبداً. ومُجازاة الحقّ عبارة عن إظهار نتائج أفعال العباد،فإنه موجد على الإطلاق والأفعال الصادرة عن الخلق مواد نتائجها،فالنتائج بحسب الموادّ. فإذا كانت المواد متوفّرة في القوة والكثرة،كانت ظهور ثَمراتها عظيمة شريفة. وإذا كانت ــ أعني المواد ــ ضعيفة القوة ويسيرة،تأخّر ظهور النتيجة واستهلكت في ضمن قوة أضدادها. وهذا من سرّ العفو والمغفرة وسرّ التبديل..
فك ختم الفص العُزيري:اعلم أن الحقّ لا يعيّن من نفسه شيئاً لشيء أصلاً،صفة كان أو فعلاً أو حالاً أو غير ذلك،لأن أمره واحد وهو عبارة عن التأثير الوحداني بإفاضة الوجود الواحد المنبسط على الممكنات القابلة له والظاهرة به والمُظهرة إيّاه،متعدّداً متنوعاً مختلف الأحوال والصفات بحسب ما اقتضته حقائقها الغير المجعولة المتعيّنة في العلم الأزليّ.فكان من مقتضى حقيقة عزير عليه السلام وأحكام لوازمها،انبعاث رغبة منه نحو معرفة سِرّ القدر،وانتباه فكره في القرية الخربة بصورة استبعاد إعادتها على ما كانت عليه. فأظهر الله له بواسطة فكره واستبعاده أنواعاً من صور الإعادة وأنواعاً من أحكام القدرة التابعة للعلم،التابع في التعلّق للمعلوم. هذا وإن كان الأكثرون يظنّون أن القدرة تابعة الإرادة، وأن الإرادة تقتضي التخصيص. والكشف المحقّق يُعطي أن الإرادة ليس لها إلا تعين التخصيص الإلهي العلمي،لا أنها مبدأ التخصيص. كما أن العلم لا أثر له في المعلوم،بلالمعلوم تعين تعلّق العلم به على حسب ما هو المعلوم عليه في نفسه من التعين والجزئية لا غير. وهذا عُمدة سِرّ القدر..
فك ختم الفص العيسوي:إقران شيخنا هذه الحكمة بالنبوة ليس بمعنى الإخبار،فإن كل من ذكره من الأنبياء في هذا الكتاب مشتركون في ذلك،وإنما مراده معنى الرّفعة. فلفظ النبي قد ورد بالهمزة وبدونه،فبالهمزة هو مشتق من النّبأ وهو الإخبار،وبدون الهمزة هو من نَبا ينبو إذا ارتفع.. تفاوت درجات الموجودات: اعلم أن الموجودات متفاوتة الدرجات في الشرف والخسّة والنقص والكمال: فأيّ موجود قَلّت الوسائط بينه وبين موجِده، أوارتفعت،وقَلّت فيه أحكام الكثرة الإمكانية وقَويت نسبته من حضرة الوحدانية الإلهية،كانت أشرف وأتمّ قُرباً من الحق من حيث وحدانيته. وكثرة الوسائط وتضاعُف وجوه إمكاناتها،مع وفور الأحكام الإمكانية في الموجود،يقتضي بخسّته ونُزول درجته وبُعد نسبته من حضرة الوحدانية.وأما النقص والكمال: فهما بحسب وُفور الجمعية بين الصفات الإلهية والحقائق الكونية،لأنها المستلزمة لوفور الحظّ من صورة الحضرة الإلهية التي حذى عليها الصورة الآدمية والقُرب من مرتبة المُضاهاة،أو بحسب نَقصه ــ أعني نقص الحظ المذكور.فأيّ موجود كان أكثر استيعاباً للصفات الربانية والحقائق الكونية، ظاهراً بها بالفعل،كانت نسبته من حضرة المضاهات والخلافة الإلهية أقرب، وحظّه من صورة الحضرة أوفر. والأقلّ حظّاً ممّا ذكرنا له النقص.وبرزخ البرازخ: الجامع بين الغيب الذاتي الإلهي الإطلاقي وأحكام الوحدانية الوجوبية وبين الحقائق والخواص الكونية وأحكامها الإمكانية،على سبيل الحيطة،له الكمال الذي تستند إليه مرتبة الخلافة الكبرى..وما من موجود إلا وارتباطه بالحق من وجهين: إحداهما جهة سلسلة الترتيب والوسائط،والأخرى لا حُكم فيها لواسطة من الوسائط أصلاً. والمحققون يُسمّون الوجه الذي لا واسطة فيه بين كل موجود وبين ربه بالوجه الخاص،غير أن باب هذا الوجه مسدود عن أكثر الخلق من حيثُهم.. الحروف: واعلم أن جبرائيل وميكائيل وغيرهما ــ ما عدا القلم الأعلى ــ يأخذون عن الله بواسطة وبغير واسطة،وكذلك الأكابر من الأنبياء والأولياء. ومن جملة ما أخذه جبرائيل عن الله بلا واسطة: الكلمة الإلهية العيسوية التي ألقاها إلى مريم، وتلك الكلمة مُتحصّلة من الحروف التي كان اجتماعها سبباً لوجود الأرواح، وهي ثمانية حروف،وتاسعها التجلّي النفسي السّاري في كل موجود. والموجب لظهور السرّ الإلهي المتعيّن بعيسى عليه السلام وفيه،هومعنويات تلك الحروف، وهي عبارة عن جملة أحكام الوجوب التي هي آثار الأسماء الذاتية وتوجهاتها بتجلّي الحق من حيث هي في مرتبة الألوهية،وتعيّن ثمانية قابليات في المؤثّر فيه ــ وهو تاسعها..فتلك ثمانية عشر،ومظاهرها من الحروف هذا الترتيب: الباء والجيم والدال والهاء والواو والحاء والطاء والياء والكاف والميم والفاء والقاف والراء والتاء والثاء والخاء والسين والظاء. وسبب اختلاف وجود الأرواح وأحوالهم هو بحسب المرتبة التي يقع فيه الاجتماع بين توجهات الحقائق المذكورة وما يُقابلها من قابليات حقائق الأعيان المؤثّر فيها.والحروف الغير المنقوطة من هذه الثمانية عشر مظاهر توجهات الحقائق المذكورة،والمنقوطة مظاهر قابليات الحقائق المؤثّر فيها،فافهم،والله أعلم. وصورة تأليفها كلّها هي حقيقة روحيّة عيسى،وصورة عيسى مُكوّنة من صيغة الكلمة الإلهية بالصفة الجبرائيلية. وبسبب ثباتها في هذا العالم مدّة هو مُكتسب من سِرّ طبيعة مريم،وموجِب سِراية القوة الطبيعية من مريم فيما نفخه جبرائيل من الكلمة هو خاصية التمثيل الجبرائيلي بشراً سويّاً،وحال الفعل هو من وجه شبيه بالاحتلام. ولما كان مقام جبرائيل بالسدرة،والسدرة مقام برزخي لأنه متوسّط بين عالم الطبيعة العنصرية وبين عالم الطبيعة الكلية.. ولهذا كانت صورة جبرائيل التي جاء بها مشتملة على خواص ما فوق السدرة وما تحتها.وأما إحياء عيسى الموتى: فلغلبة السرّ الروحي المعجّن فيه.وأما الإذن الإلهي له: فعبارة عن تمكين الحق له من فعله ما فعل،وذلك من آثار الأسماء الذاتية وتوجهاتها ــ التي قُلت إنها حروف كَلمته وحِلية صورته،هي من النسبة الحاصلة من الصورة الجبرائيلية. ومن عَلم أن جبرائيل هو روح طبيعة عالَم العناصر وما ظهر عنها.. عَلم أن عيسى،منوجه، هوصورة روحانية جبرائيل ومَظهر مقامه عند السدرة الموصوفة بالبرزخية،كما أن مريم صورة الطبيعة الكبرى.. سِرّ خَتميّة عيسى: وأما سرّ ختميّته عليه السلام فثابتة من وجهين:أحدهما: من جهة ما تضمّنته الإشارة الإلهية بقوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) فآدم أول مظهر بصورة الجمعية الحقيقية الإنسانية الإلهية التي بها ختم الحق مراتب الإيجاد. وعيسى ظهر بصفة روح تلك الجمعية،لاصورتها،فإن صورته عرضية ومرتبتها مثالية. فمُماثلة عيسى لآدم ثابتة من حيث الجمعية والختمية.. ولما كانت روحية عيسى كُليّة عامة الحُكم بالنسبة إلى صورة الكون، وأضافها الحق إلى نفسه لا بطريق التبعيض،بل بطريق التشريف،مع ما عُلم أن للروح بالنسبة إلى الصورة في التعيّن والظهور مرتبة الآخرية،ولهذا توقّف تعيّن الأرواح الجزئية وتعلّقها بالأبدان للتدبير المستلزم للإستكمال،على صورة المزاجية التي لها درجة الأولية،عَلم أن ختم مرتبة الإيجاد الإنساني الذي ظهرت به الحقيقة الإنسانية الجامعة الإلهية إنما يكمُل بالنّفخ الروحي..والوجه الآخر: هو ما أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت المتضمّن جملة من آثار الساعة وأماراتها،وفيه: أنه إذا قبض عيسى ومن معه من المؤمنين بريح تأتيهم من قبل الجنة ــ وفي رواية: من قبل الشام،وفي رواية: من قبل اليمن ــ تأخذهم من تحت آباطهم فيموتون فلا يبقى على وجه الأرض مؤمن،ويبقى شِرار الناس يتهارشون تعارش حمر الوحش في البرية،لا يحلون حلالاً ولا يحرمون حراماً،فعليهم تقوم الساعة اهـ. فإذا لم يبق يومئذٍ على وجه الأرض مؤمن،فأحرى أن لا يبق وليّ، فثبت ختميته من هذا الوجه أيضاً.وأما حظه من الجمعية الإنسانية: فصفة كلية من صفات روح الجمعية،وهو الموجِب لدخوله في دائرة الشريعة المحمدية.. فلمّا قَويت نسبته عليه السلام من روح الجمعية الإنسانية وَجب دخوله في دائرة الشريعة الجامعة التي هي خاتمة الشرائع،وانصباغ ما يوحى به إليه بصبغة الشريعة المحمدية،فافهم.وأما نزوله فلأمرين: أحدهما تَتْميم أحكام روح الجمعية،والأمر الآخر هو تنبيه على طلوع الفجر الأخراوي،ولهذا يُحارب الدجّال. فإن الدجّال مَظهر حقيقة الدنيا وحُكم الحق فيها،ولهذا كان أعور العين اليمنى،فإنهعديم روح مرتبة الربوبية التي روحها الآخرة دار الحيوان،فالنزاع بين مظهر الدنيا والآخرة..
فك ختم الفص السليماني:الرحمة: اعلم أن الرحمة تنقسم،أوّلاً،على قسمين: أحدهما الرحمة الذاتية،والأخرى الرحمة الصفاتية. وكل واحد من هاتين الرحمتين تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فيصير أربعة فصول هي الأمّهات،ثمّ يتفرّع من هذه الأمهات ستة وتسعون فرعاً فتكون مائة..قال تعالى في أم الكتاب: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم). فاللّتان في البسملة هما: الذاتية،العامة والخاصة. واللتان في الفاتحة هما: الصفاتية،العامة والخاصة. وباقي الرحمات متفرعة عن هذه.أما الرحمة الخاصة الذاتية: فهي العناية،والمُسمّاة أيضاً بقدم صدق التي هي من آثار حُبّ الحق بعض عباده،لا لموجب معلوم على التعيين،من علم أو عمل أو غيرهما من الأسباب والوسائل، وإليه الإشارة بقوله تعالى في حق الخضر: (ءاتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً).وأما الرحمة الخاصة الصفاتية: فخصيص بالسعداء،وينقسم حُكمها إلى قسمين: قسم مؤقّت،وقسم غير مؤقّت.فالرحمة المؤقتة: يختص بالسعداء في الدنيا،الفائزين بنَيْل مُراداتهم في غالب الأحوال والأوقات ــ دون الآخرة ــ ولهذا نبّهنا الحق بما يُفهَم منه استثناء سليمان عليه السلام بقوله تعالى: (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) فجمع له السعادتين،فلم تكن سعادته مؤقّتة،بل أبديّة الحُكم.. والرحمة غير المؤقّتة: فتختصّ بأهل الجنة،لأن نعيمهم أبديّ..
مراتب الوجود: واعلم أن لهذا الوجود،من حيث مبدأ انبساطه وتعيّنه من غيب هوية الحقّ،مراتب كليّة في التعيّن والظهور: أولها عالَم المعاني،ثمّعالم الأرواح التي نسبتها إلى مرتبة الظهور أتمّ من نسبة عالم المعاني،ثمّعالم المثال المجسّد الأرواح والمعاني،بمعنى أنه لا يظهر ولا يتعيّن فيه شيء إلا متجسّداً،ثمّ عالم الحسّ الذي أوّله صورة العرش المحيط بجميع الأجسام المحسوسة المحدّدة الجهات،وبه انتهى،أي استوى السّيْر المعنوي الوجودي الصادر من غيب الهوية في مراتبه الكلية للظهور الذي غايته عالم الحسّ. لأن تعيّنات الوجود وتنوّعات ظهوره،بعد العرش، إنما هو تفصيل وتركيب.. ولهذا أضيف الاستواء إلى الاسم الرحمن،دون غيره من الأسماء،لأن الرحمن صورة الرحمة التي وسعت كل شيء،وانتهتظهوراته الكلية في العرش.وأما الحُكم العام الوجودي: فإنه يظهر في كل مرتبة من المراتب الأربعة الكليّة المذكورة،ويتفصّل فيما يَليها من المراتب التفصيلية بحسب تلك المرتبة..فإن فهمت ما نبّهت عليه في هذا الفصّ،استشرفت على أسرار غريبة،من جملتها سِرّ الاستواء،فتلقاه صادقاً: بمعنى التماميّة في درجات السّير المعنوي لتكمُل مراتب ظهورات الوجود،وبمعنى الاستيلاء الحُكمي..ولم تزل الأحكام والآثار وخواص الظهوراتالتعينيّة تبرُز من الغيب إلى الشهادة،ومن القوة إلى الفعل،ومن حضرة البطون إلى حضرة الظهور،في الطور الإنساني أيضاً،كالأمر فيما ذكر من قبل بالتدريج والحُكم والفعل،حتى انتهى الأمر من الوجه المذكور إلى داود وسليمان. وكان داود مظهر كليّات تلك الأحكام الأسمائية والصفات الربانية والآثار الروحانية، والقوى الطبيعية مُستجمعها، فاستحقّ الظهور بمقام الخلافة وأحكامها وأحكام الحكمة وفصل الخطاب. ووَرثه سليمان في الجمع،وزاد بالتفصيل الفعلي والحكم الظاهر الجليّ والتسخير العام الكلّي العليّ..
فك ختم الفص الداوُدي:اعلم أن كثيراً ممّا عزمت بمشيئة الله تعالى على ذكره في شرح هذا الفصّ هو من وجه كالتتمّة لمما ذكر في بيان أسرار أحوال سليمان، فإنبين أسرار أحوال سليمان وداود عليهما السلام اشتراكاً عظيماً قد نبّه الحق سبحانه في كتابه عليه بقوله: (ولقد ءاتينا داود وسلميان علماً)،وأيضاً اشتركا في الأمر والحُكم: (وداود وسليمان إذ يحكُمان في الحرث)..وذلك سرّ إقران شيخنا هذه الحكمة بالوجود حيث قال: حكمة وجودية في كلمة داودية،فكأنّه أشار إلى شيء ممّا أوضحته من سرّ الوجود وسَيْره في درجات ظهوره وكونه عين الرحمة التي وسعت كل شيء.. خلافة داود: فبروز الوجود وأحكامه من الغيب إلى الشهادة كان بالتدريج حتى انتهى الأمر إلى النوع الإنساني،فصار ذلك الظهور على وجه آخر مخصوص،ثمّ لم يزل يظهر الأمر بسير آخر في مراتب الاعتدال التي يتضمنها عرض النوع الإنساني. فإن الخلافة لم تبسُط حُكمها تاماً بآدم،لقلّة وجود المستخلفين عليهم،فلم يكن ثمّة من تنبسط عليه أحكام مرتبته إلا طائفة يسيرة من ذريّته. ولهذا لم تتضمّن خلافته مرتبة الرسالة،بل بقيت فيه بالقوة وفيما خلف من ذراريه والمتناسلين منهم بعده إلى زمان نوج الذي هو أول المرسلين.فما برحت أحكام الخلافة،من حيثها ومن حيث مرتبة المستخلف،يزداد ظهوراً وانبساطاً ــ كالوجود ــ حتى انتهى الأمر إلى داود،فتمّ بوجوده مرتبة الخلافة وانبسطت أحكامها في الوجود بحسب درجات الأكمليّة،بعد استيفاء ما هو شرط في حصول مقام الكمال. وكمُل انبساط الأحكام والصفات المذكورة بابنه سليمان..ومن جملة ما رجحت به خلافة داود على خلافة آدم: أن حظّه من الأسماء،على ما صرح به،كان علمه بها. وأما داود: فتحقّق بها علماً وحالاً وعملاً..
فك ختم الفص اليونسي:اعلم أن كل نبيّ ووليّ،ما عدا الكمّل منهم،فإنه مظهر حقيقة كليّة من حقائق العالم والأسماء الإلهية الخصيصة بها وأرواحها الذين هم الملأ الأعلى،على اختلاف مراتبهم ونسبهم من العالم العلوي..سرّ تسمية شيخنا هذه الحكمة بالحكمة النفسية هو من أجل أن يونس كان مظهراً للصفة الكلية التي تشترك فيها النفوس الإنسانية.. فيونس عليه السلام،من حيث أحواله المذكورة لنا في الكتاب العزيز،مثال ارتباط الروح الإنساني بالبدن،والحوت مثال الروح الحيواني الخصيص به،والسرّ في كونه حوتاً هو لضعف صفة الحياة فيه.. واليَمّ مثال عالم العناصر،ووجه شَبهه باليمّ هو أن تراكيب الأمزجة المتكونة من العناصر غير متناهية..
فك ختم الفصّ الأيّوبي:اعلم أن في تسمية هذه الحكمة بالحكمة الغيبية سرّين كبيرين أنبّه عليهما إن شاء الله:السرّ الأول: هو أن المحَن والبلايا،من حيث صورتها،مؤلمة بالنسبة إلى جميع الناس،غير ملائمة لنفوسهم وطباعهم،ولا يصبر عليها إلا من قويت نسبته من العوالم الغيبية وجزم بحسن نتائجها وثمراتها المَرضيّة..والسرّ الآخر: هو أن الإنسان،وإن جزم عن إيمان محقّق أو عِيّان،أن للصبر على المحن ثمرات مرضية،فإنه لا يلزم من ذلك رجوع ما ذهب عنه بعينه،فكيف أن يُعاد إليه عين ما تَلف ومثله معه في الدنيا؟.. البلاء والمحن: البلاء والمحن التي تلحق بالأنبياء والأكابر من أهل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام،لكل قسم منها موجب وحُكم وثمرة:القسم الأول: فتارة يكون بالنسبة إلى البعض مَصاقيل لقلوبهم ومُتمّمات لاستعداداتهم الوجودية المجعولة،ليتهيّئوا بتلك الأمور لقبول ما يتمّ به لهم أذواق مقاماتهم التي حصّلوها ولم يكمُل لهم التحقيق بها،فيكون تلبّسهم بتلك المحن سبباً لاستيفائهم ذوق مقامهم الناقص وترقّيهم فيه إلى ذروة سنامه الموجب الاطّلاع على ما فيه..القسم الثاني: موجبه هو سبق علم الحقّ بأن المقام الفلاني سيكون لزيد لا محالة،مع علم الحق أيضاً أن حصول ذلك المقام لمن قدر حصوله له لا بدّ وأن يكون للكسب فيه مدخل، فلا تتمحّض الموهبة الذاتية فيه. فإن ساعَد القدر الإلهي والتوفيق بارتكاب الأعمال التي هي شروط في حصول ذلك المقام،كان ذلك. وإن لم يُساعد القدر ولم يَف العمر باستيفاء ذلك المشترط ارتكابها للتحقّق بذلك المقام،أرسَل الله المحن على صاحب المقام ورزقه الرضاء بها والصبر عليها، وحبس النفس فيها عن الشكوى إلى غير الله.. فكان ذلك كله عِوَضاً عن تلك الأعمال المشترط فيها..القسم الثالث: موجبه هو سعة مرآة حقائق الأكابر المُضاهية للحضرة الإلهية المترجم عنها بقوله تعالى: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه). فكما أن حظّهم ممّا يعطي السعادة ويُثمر مزيد القرب من الحق سبحانه والاحتظاء بعطاياه الاختصاصية أوفر، فكذلك قبول ما لا يُلائم الطبع والمزاج العنصري الذي به تمّت الجمعية وصحّت المُضاهاة..
فك ختم الفص اليحيوي:اعلم أن موجب تسمية هذه الحكمة بالحكمة الجلالية أمران: أحدهما يختصّ بحال يحيى عليه السلام،والآخر يختص بذاته وصفته واسمه.الأمر الأول: ثبت أن الحق سبحانه ذو الجلال والإكرام،ومن أسمائه الجليل. وليس في الوجود من يستهلك كثرة صفاته وأسمائه في وحدة ذاته،بحيث يضمحلّ لذاتها كل عدد ومعدود،إلا الحق سبحانه. فمن عنايته بشأن يحيى ــ وإن جعل له من هذا الكمال نصيباً ــ فأنزله منزلة نفسه،فأدرج اسمه وصفته في وحدة ذاته،ولم يفعل ذلك بغيره ممّن وُجد قبله..والأمر الثاني: أنه ينبغي أن يعلم أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات حالية. فالصفات الذاتية واضحة عند الأكثرين،والصفات الحالية كالغضب والرضاء والقبض والبسط ونحو ذلك. وهذه الصفات الحالية،في اصطلاح أهل طريق الله،ترجع إلى ثلاثة أصول: أحدها مقام الجلال،والثانيمقام الجمال،والثالث مقام الكمال. وكان الغالب على ظاهر يحيى الأحوال الجلالية..
فك ختم الفص الزكرياوي:اعلم أن سرّ وصف حكمته بالحكمة المالكية من أجل أن الغالب على أحواله كان الاسم المالك،لأن الملك الشدّة،والمليك الشديد. فأيّده الله بقوة سَرَت في همّته وتوجّهه،فأثمرت الإجابة وحصول المراد. وقد نبّهتك أن الهمّة من الأسباب الباطنة،والأسباب الباطنة أقوى حُكماً من الأسباب الظاهرة المعتادة وأحقّ نسبة إلى الحق،ولهذا كان أهل عالم الأمر أتمّ قوة من أهل عالم الخلق وأعظم تأثيراً.. فك ختم الفص الإلياسي:إنما أضيفت هذه الحكمة بالصفة الإيناسية من أجل الصفة الذاتية التي جبل الله بها إلياس حتى ناسب بها الملائكة وناسب بها الأناسي،فثبت له الأنس مع الطائفتين،فكانوا يأنسون به ويجلسون إليه.. والسرّ أن بين قوى الأرواح العالية والقوى المزاجية الإنسانية امتزاجات على أنحاء يحدث بينهما فعل وانفعال وغلبة ومغلوبية،ينتهي إلى كيفيات معقولة شبيهة بالامتحان الواقعة في هذا العالم، مثل استحالة الماء هواءً والهواء ناراً ونحو ذلك.. التروحُن: فمن الأناسي المتروحنين من ينتهي في تروحُنه إلى الرتبة الملكية، فتستهلك قواه المزاجية الطبيعية في قوى روحانية ثابتة الحكم بحسب استيلاء سلطنة تلك القوى الروحانية على القوى الطبيعية.وظهور من هذا شأنه في هذا العالم إنما هو كظهور الملَك هنا بشراً سوياً. والرّائي لمن هذا شأنه إنما يراه بموجب حُكم إحدى المناسبات الخمس وهي:الذات والمرتبة والصفة والفعل والحال.فإن ثبتت المناسبة بين الرائي والمرئي، من حيث الذات: يراه في صورته الأصلية التي كان عليها قبل تروحنه. وإن لم تثبُت المناسبة من حيث الذات،كانت رؤيته له بحسب المرتبة التي تجمعهما في الأصل. أو بحسب الصفة التي يشتركان فيها،أوالفعل أو الحال.وكيفية الصورة المرئية يكون بحسب كمال الصفة المشتركة فيها ونقصانها،وكذلك الفعل والحال.وأما الاشتراك في المرتبة: فيتفاوت الأمر فيها بحسب تفاوت حظوظها منها،وهذا شأن الخضر.وعكس ذلك شأن عيسى، فإن نسبته ملَكية،فظهوره في الصورة الطبيعية هو من أجل أمه التي كانت محل الإلقاء والنفخ. فكينونة كل شيء في شيء إنما يكون بحسب المحلّ، سواء كان المحل معنوياً أو صورياً. واذكُر ما أشار الحق سبحانه إليه: (وهو معكم أين ما كنتم) فأدخل نفسه مع عباده في الأمكنة، مع أنه منزّه عن الزمان والمكان.. وتذكّر أيضاً ما اتّفق عليه المحققون من أن تجلّي الحق لمن تجلّى له،إنما يكون بحسب المتجلّىله،لا بحسبه..
فك ختم الفص اللّقماني:مراتب الإحسان: اعلم أن سرّ إقران هذه الحكمة بالصفة الإحسانية هو من أجل أن للإحسان ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: بين أحكام المرتبة الأولى وبين أحكام الحكمة اتّحاد واشتراك،فهما من ذلك الوجه كالأخوين. فإن حكم الأول ومقتضاه هو: فعل ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي، ومقتضى الحكمة وضع الشيء في موضعه على الوجه الأوْفَق وضبط الحكيم نفسه.. والوصايا وجميع النصائح والآداب،داخلة في أحكام هذه المرتبة الإحسانية.. المرتبة الثانية: هي التي سأل عنها جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما الإحسان؟ فأجابه:الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه اهـ. وهو عبارة عن استحضار الحق على نحو ما وصف نفسه به في كتبه وعلى ألسنة رسله،دون مزج ذلك بشيء من التأويلات السخيفة بمجرد الاستبعاد وقصور إدراك العقل النظري عن فهم مراد الله من إخباراته وجنوحاً إلى الأقيسة وتوهّم التشبيه والاشتراك في الصفات.والمرتبة الثالثة: تختصّ بالمشاهدة دون كأنّ،كما قيل لبعض الأكابر: هل رأيت ربّك؟ فقال: لم أعبد ربّاً لم أرهاهـ،وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرّة عيني في الصلاة،وقوله: الصلاة نور اهـ.. وإلى هذا المعنى الإشارة في الآية التي هي في سورة لقمان: (ومن يُسلم وجهه إلى الله وهو محسن) أي: ومن ينقاد برمّة ذاته إلى الله وهو مشاهد (فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور).فليُعلَم أن لكل صفة من هذه الصفات ثلاث مراتب: أولى ووسطى وعليا. وتدبّر قوله تعالى: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتّقوا وآمنوا ثم اتّقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين)،وتنبّه بختم الآية بذكر الإحسان وإقران محبّة الحق بالمحسنين..
فك ختم الفص الهاروني:الإمامة: اعلم أن الإمامة المذكورة في هذا الموضع ومثله،فإنما تذكر باعتبار أنها لقب من ألقاب الخلافة،ولها التحكّم والتقدّم. وهي تنقسم،منوجه،إلى: إمامة لا واسطة بينها وبين الحضرة الإلهية،وإلى إمامة بالواسطة. والخالية عن الواسطة قد تكون مطلقة عامة الحكم في الوجود،وقد تكون مقيّدة. بخلاف الإمامة الثابتة بالواسطة ،فإنها لا تكون إلا مقيّدة.والتعبير عن الإمامة الخالية عن الواسطة مثل قوله للخليل: (إنّي جاعلك للناس إماماً).. والتي بالواسطة مثل استخلاف موسى هارون على قومه حين قال له: (اخلفني في قومي)،ومثل ما قيل في حق أبي بكر أنه خليفة رسول الله. وهذا بخلاف خلافة المهدي،فإن رسول الله لم يُضف خلافته إليه،بل سماه خليفة الله،فأخبر بعموم خلافته وحُكمه،وأنه خليفة الله بدون واسطة، فافهم.وسرّ إضافة هذه الحكمة إلى الإمامة: أن كل رسول بُعث بالسيف فهو خليفة من خلفاء الله،وأنه من أولي العزم. فإن كثيراً من الناس لم يعرفوا معنى أولي العزم،فهم الذين يُبلّغون رسالات ويُلزمون من أرسلوا إليهم بالإيمان،فإن أبوا قاتلوهم. بخلاف إذا لم يُؤمر الرسول بالقتال،فإنه ما عليه إلا البلاغ،كما كان الأمر في أول عهد نبينا صلى الله عليه وسلم..ولا خلاف في أن موسى وهارون بُعثا بالسيف،فهما من خلفاء الحق الجامعين بين الرسالة والخلافة. فهارون له الإمامة التي لا واسطة بينه وبين الحق فيها،وله الإمامة بالواسطة من استخلاف أخيه إيّاه على قومه،فجمع بين قسمي الإمامة،فقَويت نسبته إليها،فلذلك أضيفت حكمته إلى الإمامة دون غيرها من الصفات..
فك ختم الفص الموسوي:اعلم أن سرّ إضافة هذه الحكمة إلى الصفة العلوية هو من أجل عُلوّ مرتبة موسى عليه السلام ورجحانه على كثير من الرسل بأمور أربعة: أحدها أخذه عن الله بدون واسطة ملَك وغيره،والثانية كتابة الحق له التوراة بيده.. والثالث قُرب نسبته من مقام الجمعية التي خصّ بها نبينا صلى الله عليه وسلم.. والرابع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير أمّة نبي من الأنبياء أكثر من أمة موسى..
فك ختم الفص الخالدي:اعلم أن للاسم الصمد معنيين : أحدهما باعتبار أن الصمد هو الذي لا جوف له،والآخر هو بمعنى القصد والالتجاء. والمعنى هنا: معنى القصد والالتجاء،والسرّ فيه أن خالداً لم يُظهر حُكم نبوته مع قومه في الحسّ ــ لمخالفتهم إيّاه ــ فأوصاهم أن يقصدوا قبره بعد موته بسنة،فإذا مَرّ بهم قطيع من الغنم فيه حمار مقطوع الذنب نبشوه فيُخبرهم بما شاء الحق فيما أطلعه عليه،فلم يُمكّن بنوه من ذلك،فلم تظهر أحكام نبوّته،فكانتنبوته برزخية..
فك ختم الفص المحمدي:لقب شيخنا هذه الحكمة بالحكمة الكليّة والحكمة الفردية، ولكل واحد من اللّقبين سِرّ.. الوجه الخاصّ لكل موجود: اعلم أن كل شيء فإنه مظهر من مظاهر الحقّ،لكن من جهة حيثية مخصوصة واعتبار معيّن،فيتعيّن للحق من حيث ذلك الاعتبار وتلك الحيثيّة بما يوجد بهما من الممكنات اسم من شأنه أن لا يستند ذلك الموجود إلى الحق إلا من حيث ذلك الاعتبار وتلك الحيثيّة.وهكذا هو شأن كل موجود مع الحقّ،غير أن الفرق بين الأنبياء والأكابر من أهل الله وغيرهم: أن الأنبياء والأكابر مظاهر الأسماء الكليّة التي نِسبتها إلى الأسماء التي يستند إليها بقيّة الموجودات،وعمومالناس،نِسبة الأجناس والأنواع إلى الأشخاص. ثمّ كما أنه بين الأجناس والأنواع تفاوُت في الحُكم والحيطة،كذلك هو الأمر في مقام المفاضلة بين الأنبياء والأولياء..كل نبيّ ووليّ،ما خَلا نبينا صلى الله عليه وسلم والكمّل من ورثته،إنما يستند إلى الحق ويرتبط به من جهة حيثية معيّنة واعتبار مخصوص يُسمّى اسماً من أسماء الحقّ. ذلك أن الحق،من حيث إطلاق ذاته وصرافة وحدته ووحدته فيضه الذاتي،لا يرتبط به شيء ولا يستند إليه موجود ما من الموجودات. وقُصارى الأكابر من أهل الله أن ينتهي ارتباطهم بالحق صعداً إلى التعيّن الأول، التالي للأحديّة الذاتية،الجامع للتعيّنات كلها المُضافة إلى الحق باعتبار وحدانيته من حيث إنها مشرع الصفات والأسماء،ويُسمّيها بعضهم بأحكام الوجوب التي هي نتائج الحيثيات والاعتبارات. والمُضافة أيضاً إلى مرتبة الإمكان من حيث أحكام المعلومات الممكنة المعدّدة بتقيّداتها الإمكانية المتكثّرة واستعداداتها المتفاوتة المختلفة للوجود الواحد الفائض من الحق بالوجود الذاتي المطلق..وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم،والكمّل من ورثته،مع التعيّن الأول،مُخالف لشأن غيرهم. فإن هذا التعيّن ليس هو غايتهم من كل وجه في معرفة الحق واستنادهم إليه،بل هم متفرّدون بحال يخصّهم لا يعرفه بعد الحق سواهم،ولا يذكرونه لأحد إلا لمن اطّلعوا على أن ذلك الشخص لا بد له أن يصير إنساناً كاملاً،فينبّهونه على هذا ومثله تربية له.. المفاضلة في الرسالة: آيات كل نبيّ هي عبارة عن أحكام اسم الحق الذي تستند إليه رسالته ونبوته،وهذا سرّ من أطلعه الله عليه عرف سبب تفاوت درجات الأنبياء والأولياء ومراتبهم في الولاية والنبوة والرسالة،وسرّ قوله تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض). وأن تلك المُفاضلة،وإن ثبتت على أنحاء، فليست من حيث نفس الرسالة،كما قال تعالى: (لا نفرّق بين أحد من رسله) في صحّة استنادها إلى الحق، لوحدة الرسالة من حيث حقيقتها. وإنما التفاوت في مشرعها واستنادها إلى أي صفة أو اسم،ولا خفاء في تفاوت مراتب الصفات والأسماء في سعة الحُكم والحيطة والتعلّق وقوة التأثير..فكل نبيّ أتى بآية تختص بأصل من أصول العالم،كاختصاص نوح في الماء،وإبراهيم بعمارة الكعبة وبالنار وبشهود كيفية التركيب المطلق الكلّي العنصري.. فيفضُل غيره بسعة الدائرة والحُكم،لقُرب نسبته من حضرة الجمعية الإحاطية التي انفرد بها نبيّنا صلى الله عليه وسلم. فالأقرب نسبة إلى مقام جمعيّته أعلا نبوة وأتمّ حيطة.
لخصه الفقير الى عفو ربه رشيد موعشي